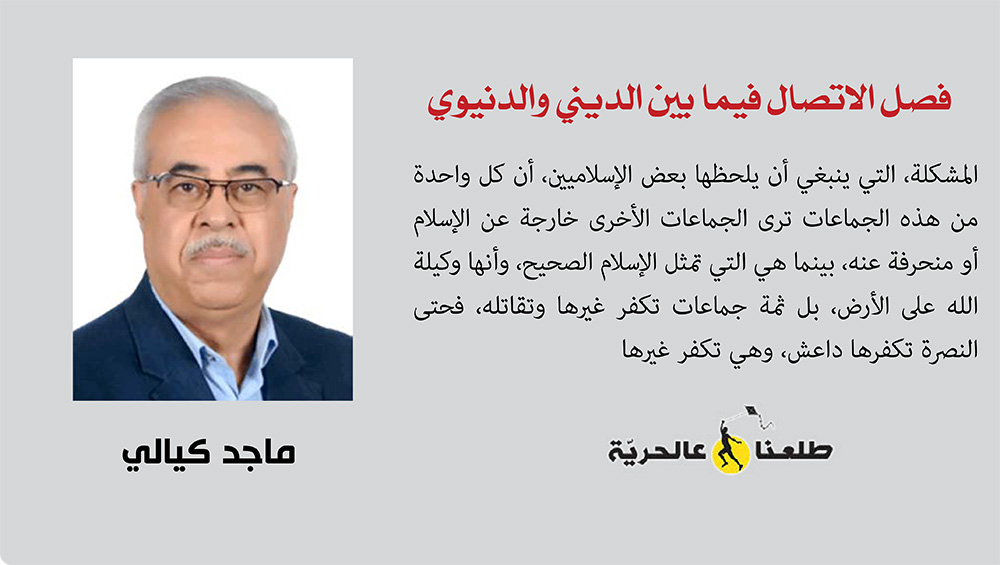مازال البعض لا يدرك أهمية التمييز بين شؤون الدين وشؤون الدنيا، على أساس رؤية مغلقة مفادها أن الدين لم يترك شيئا لم يقله، وهو قول عمومي، أو شعاراتي، ينم عن رؤية بسيطة ومتعسفة ومتسرعة، تضر الدين أكثر مما تتنصر له؛ إذ هي تحمله أكثر مما يحتمل، وتخلط بينه باعتباره مجرد رؤية عامة مقدسة للكون والبشر ومقاصد الخلق، وضمن ذلك العبادات والمسلكيات، وبين شؤون الدنيا التي تتعلق بتفاصيل الحياة بصغيرها وكبيرها، وضمنها صنع التاريخ وبناء المجتمعات وانتهاج السياسات وصوغ العلاقات الدولية، وهي مسائل تخضع للتساؤل والمساءلة.
معلوم أن الرسول الكريم هو الذي قال: “أنتم أعلم بشؤون دنياكم”، وقد عرف عنه استشارته كبار الصحابة بخصوص متطلبات الحياة في المدينة المنورة، وضمنها خوض الحرب أو السلم، فالدين لم يتحدث عن تنظيم المدن أو كيفية بناء الطرق وإدارة الجامعات، ولا عن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وإذا كان تحدث عنها فأين؟ ولماذا إذاً لا نتقدم؟ ثم الأهم: لماذا مازلنا نعتمد في حياتنا على نتاجات الغرب من إبرة الخياطة إلى الكومبيوترات والسيارات والأدوية والسلاح؟
القصد أنه آن لنا، بعد هذه التجربة المريرة، أن ندرك أن إقحام الدين في كل شيء يجعل منه مجرد أداة للاستخدام والاستغلال، وينزع عنه قدسيته، كما من شأن ذلك ظهور محاولات تطويعه لأغراض سلطوية، أو تتعلق بتعزيز المكانة وتعظيم المصالح. ومن أهم انعكاسات إقحام الإسلام في السياسة أنه يولد “إسلامات” جديدة، بمعنى ما، متباينة ومختلفة عن بعضها البعض، على نحو ما حصل في التجربة التاريخية وما يحصل في أيامنا هذه؛ وهذا يختلف تماماً عن اعتماد الإسلام كمرجعية لأحزاب سياسية معينة.
هذا الوضع يحيلنا إلى سؤال: أي إسلام نريد؟ “السني” أم “الشيعي” أم واحد غيرهما؟ هل إسلام قم أم النجف أم مكة أم الأزهر؟ ثم لدينا إسلام “الولي الفقيه” وآيات الله في إيران، ولدينا إسلام حزب الله في لبنان وكتائب أبو الفضل العباس في العراق، والحوثيين في اليمن. كما ثمة إسلام “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان وحزب التحرير وحزب النهضة وحزب العدالة والتنمية (التركي)، وغير ذلك كثر.
المشكلة، التي ينبغي أن يلحظها بعض الإسلاميين، أن كل واحدة من هذه الجماعات ترى الجماعات الأخرى خارجة عن الإسلام أو منحرفة عنه، بينما هي التي تمثل الإسلام الصحيح، وأنها وكيلة الله على الأرض، بل ثمة جماعات تكفر غيرها وتقاتله، فحتى النصرة تكفرها داعش، وهي تكفر غيرها وهكذا.
المشكلة الأخرى أن كل جماعة إسلامية تروج لما تعتبره إسلامها أو صحيح الإسلام، لديها منظريها من المشايخ، مع صفوف من المفتين الذين يمكن أن يبرروا أي تصرف لها. حتى بشار الأسد له مشايخه ومفتيه.
على ذلك، آن للبعض أن يتفحص بطريقة نقدية ما يحصل، بعيداً عن التعصب الديني أو الأيديولوجي، لإدراك أن الله لم يوكل أحداً عنه، وأنه هو ولي الحساب، وهو القائل “لا إكراه في الدين”، و”من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. وأيضاً إدراك أن الدين واحد في القرآن، وأنه لا اجتهاد بعد وفاة الرسول وفق النص القرآني “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً”، أي أن كل ما جاء بعد ذلك هو مجرد اجتهادات يفترض أن تنم عن روح التسامح في الإسلام، كما يفترض أن تعرض للمساءلة والفحص والنقد.
هذا يقودنا إلى عبارة “الإسلام هو الحل” وهي مجرد شعار تعبوي ينطوي على استغلال الدين، والأخطر من ذلك إظهاره كإسلامات متعددة، متطرفة ومعتدلة ومتوسطة. ينبغي التمييز بين الديني المقدس والدنيوي المدنس، وتحرير الدين من السلطة ومن التاريخ؛ فالإسلام شيء وتاريخ المسلمين شيء آخر، كما ينبغي منع استغلال الدولة للدين، واستخدامه في الأغراض السلطوية. أما الحديث عن الحاكمية لله، فهو ليس نصاً مقدساً بل مجرد اجتهاد، والأهم أن الله لم يوكل أحداً عنه في الأرض، وأن مستخدمي هذه المقولة يتوخون استغلال الدين لفرض رؤاهم، وتجنب المساءلة والنقد والمحاسبة باعتبارها من أبجديات العمل السياسي.
فصل الاتصال فيما بين الديني والدنيوي